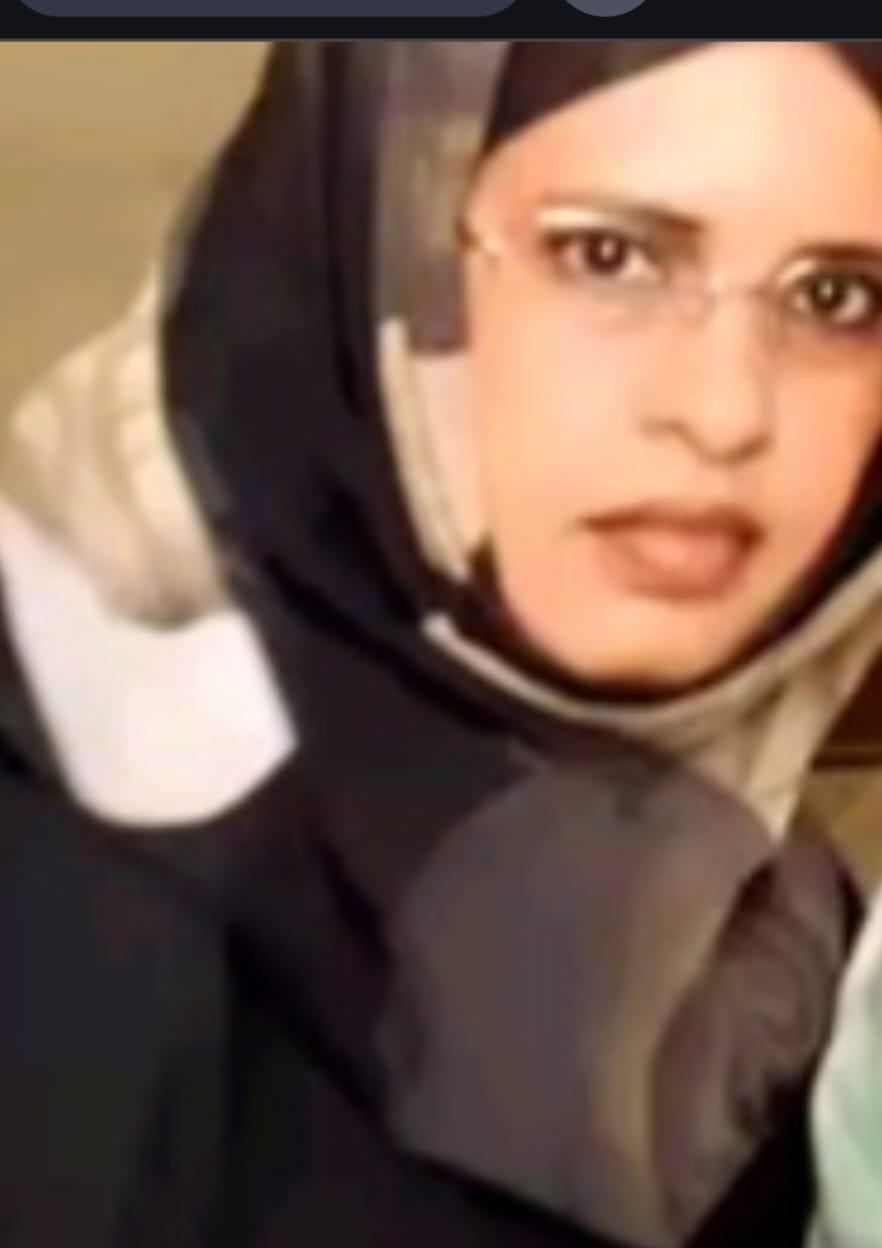قبل شهرين نظم تجمع ثقافي من شباب الجالية الموريتانية بالدوحة ندوة عمومية للحديث عن "التاريخ الموريتاني" من حيث محطاته وقضاياه. وقد اختار المنظمون للندوة أن تكون على شكل محاضرة مركزية يعلق عليها من شاء من الحضور، وهو ما يقتضي ضمنيا، من باب آداب الاستخدام العمومي الجماعي للعقل، أن تكون التعقيبات تعليقا على المحاضرة لا محاضرات موازية يمتنع معها الحوار والتباحث. وقد أثارت الندوة لدى نشرها تعليقات متباينة وكان ممن حمل عليها الدكتور عبد السلام ولد يحيى ثم الدكتور أبو العباس ولد برهام. وقد كنت أنوي التفاعل مع ما أبدياه من ملاحظات ريثما تسكن الأمواج الفيسبوكية وتهدأ الأعصاب وتخبو الالتهابات الإيديولوجية ويصبح نقاش الأفكار ممكنا دون شخصنة ولا مزايدات.
ماضينا الحاضر كتاريخ
إذا كنا حصيلة ما مر علينا من حياة وما تلقيناه من تراث حُمل إلينا من الماضي، فإن التاريخ في هذه الحالة لا يكون ما تركناه وراءنا وإنما هو ما يحاصرنا كأفق لا نخرج منه، قادما من أمامنا ليعطي لحاضرنا ومستقبلنا بعض المعنى ولمسة من خصوصية تتركه مفهوما لنا وتجعل انغراسنا فيه حقيقيا إلى أبعد الحدود. بهذا المعنى فإن تاريخنا ليس الأحداث التي مضت، وإنما هو رؤيتنا الحاضرة لما بقي من تلك الأحداث رافضا للمُضِيِّ، بحضوره الدائم معنا وفينا شعورا وهواجس وقيما وصراعات وتصنيفات وآثارا قائمة للعيان. ولذا فإن كل واحد يحمل في ذاته حدودا فرضها عليه التاريخ وأمجادا جمعها له التاريخ، فلا انفكاك لنا عنه بأي حال من الأحوال. من هذه الزاوية، ليس هنالك أي شخص غريبا على التاريخ أو لا صلة له به. إن حرمان أي شخص من تسآل تاريخه والتحدث معه بصوت مرتفع والحديث عنه هو مصادرة لأخص ما يؤسسه كإنسان، ألا وهو أفقه الرمزي والزمني الذي يحدد وجوده. إن التاريخ الموريتاني فضاؤنا جميعا ولكل منا معه تجربته المعيشة وتأويليته الخاصة التي تجعلنا مرتبطين به عاطفيا ونفسيا بحيث لا يصبح مجرد تعاقب لحظات زمنية لا رابط بينها ولا صلة تشدنا إليها. صحيح أن إنتاج خطاب متسق ومتناغم حول التاريخ قد لا يتاح للجميع، خصوصا في مجتمع يتسم بتمايز الفضاءات وتقسيم العمل ومركزة رؤوس الأموال الرمزية والعلمية والسياسية التي أنتجها ظهور الدولة الحديثة. ولكن ينبغي ألا ننسى وخصوصا ألا ينسى المؤرخ -الحديث- أن ظهوره على سطح الأحداث حدثٌ تاريخي وأن ينظر إلى عمله وحقل إنتاجه والمنطق السائد فيه ومناهجه نظرة تاريخية تحول دون جعل كل ذلك جواهر متعالية على الزمن وحركية المجتمعات. إن الخطاب الأكاديمي حول الماضي ليس الطريقة الوحيدة للحديث عن هذا الموضوع، وقد لا تكون دائما الأقرب من بحر الحقيقة بحيث أنها ليست طقوسا بمجرد القيام بها تنفتح امامك الحقائق كما جرت بالفعل، على حد تعبير أبي التاريخ الوضعي الحديث "رانكه" : Wie es eigentlich gewesen ist. إن هذا الرؤية الوضعية للتاريخ حاضرة بقوة، سواء كمقولات مصرح بها أو كمقتضيات للخطاب أو لوازم له، ولكن قبل نقاشها لنفترض ببساطة أن الخطاب الأكاديمي حول التاريخي هو طريقة تنظم المعارف التاريخية وتؤسسها كحقل وترتقي بها نحو المهنية والاحتراف، ولكنها ليس الطريقة الوحيدة للوصول إلى معارف ودروس مهمة حول الماضي.
في احتكار المناصب وانفتاح المعرفة
لا يبدو أن كل ذلك يرضي الدكتور عبد السلام الذي يتراءى من ردة فعله على الفيسبوك (سفر الوجوه) أنه يرى الكلام في التاريخ حكرا على الأكاديميين، قبل أن ينزاح بخطابه بعد ذلك ويضيق ذلك إلى المؤرخين بشكل خاص. إلا أن الهواجس التي تُلحّ على الدكتور هي من نوع آخر. إذ يبدو أن هاجسه الأكبر ليس معرفيا وإنما هو وظيفي ونقابي، إن صح التعبير. يسعى الدكتور عبد السلام إلى لجم "العوام" عن الحديث عن تخصصه حتى لا يصبح أرضا مستباحة، ربما يعين أستاذ لها من خارج التخصص. وهنا بؤرة المشكلة بالنسبة للدكتور. غير أنه فات على الدكتور أن الحديث في التاريخ لا يمكن احتكاره على أي كان، أما التوظيف فهو إجراء سياسي وقانوني يتعلق بنقطة منفصلة. إن ما وقع فيه الدكتور هو ما يسمى لدى المناطقة الأقدمين ب"انفكاك الجهة"، لقد أراد تضييق مجال التوظيف، فانزلق حديثه إلى التكميم المعنوي للأفواه. بيد أن الدكتور يمكن أن يَطمئن أن حديث الناس عن موضوع معين واهتمامهم به لا يحد من فرص المختصين في ذلك المجال، بل يزيدها، لأن الطلب الاجتماعي إذا زاد على مجال معين، تزايد الوعي بأهمية العرض فيه.
من النقاط المهمة التي ينبغي للدكتور عبد السلام الانتباه إليها هنا أن تخصص شخص معين لا يعني أن ذلك الشيء أصبح خصوصية أو ملكا خاصا لذلك الشخص. إنها ليس علاقة ثنائية الاتجاه، بمعنى أن التخصص لا يعني الاختصاص بموضوع التخصص. إن دراسة شخص ما لتاريخ بلد ما، لا يعني أن الناس الذين وقعت عليه أحداث ذلك التاريخ وصدمتهم خيباته وطبعتهم رؤاء وأفكاره بطابعها الخاص قد سحب من تحتهم ذلك البساط لصالح المتخصص. إن العلوم الإنسانية من حيث هي معارف لا يسري فيها قانون الحصرية، عكس المؤسسات الإدارية والمنتجات القابلة للتسليع التي تنتج من تلك المعارف. هذا يعني أن الحديث عن التاريخ مجال تتداول فيه الأفكار وتتنوع طرائق التفكير والتعبير وليست طريقة المؤرخ إلا واحدة من هذه الطرق. إن مطالبة المتحدثين عن الماضي بالتزام الإجراءات الشكلية التي التزمها المؤرخ للبحث في هذا الموضوع والتعبير عنه تشبه المُنتِج الذي لا يريد للمستهلك أن يقارب ما أنتجه هو إلا بالتعليب والأشكال التي وضعها هو عليه. وهكذا فمن الطبيعي أن تكون هواجس المتعاطين للتاريخ مختلفة عن إشكالات المؤرخ، لأنهم لا يصنعون موضوعهم، بل يستجيبون لندائه في صلة مباشرة معه. أما المؤرخ فإن عليه، كمهني، أن يُؤطر موضوعه بطريقة تلتزم بأعراف ومواضعات وتقاليد وشكليات وأشكال معينة تشمل جهازا من الإشارات السيميائية والبنى التركيبية والدلالية وشبكة من الإحالاتيفرضها حقله ومؤسساته.
يتحدث الدكتور عبد السلام بوثوقية عن "المتخصص في التاريخ" وهو مصطلح واضح وجلي حينما نفكر فيه وظيفيا وإجرائيا، بوصفه شخصادرس هذا الموضوع وحصل على شهادة عليا في مجاله. ولكن ما إن ندقق في ذلك ونسائله بجدية حتى تتلاشى كل البدهيات ولا يبقى لنا إلا تلاحم العلوم الإنسانية وعدم انفكاك بعضها عن بعض، لأن موضوعها في نهاية المطاف (الإنسان ككائن اجتماعي) وكل مكتمل لا يمكن فهمه وتجزيئه في آن واحد. ولكن لِنُجار الدكتور قليلا ونقفز معه فقزتين إلى الأمام ونفترض أن معرفة كهذه ممكنة. غير أن سؤالا ملحا سيظل يلح عليها وعليه ألا وهو كيف يمكن لأي شخص ألا يتحدث إلا عن تخصصه؟ تصور مثلا أن شخصا ما درس التاريخ في الجامعة وحصل على دكتوراه في التاريخ الوسيط، وهب أنه أراد الحديث عن أحداث سابقة تحركها ديناميكيات سياسية، فهنا سيعترضه جندي من المهووسين بالتخصص وينبهه -بخشونة- أنه تحدث في الظاهرة السياسية التي لها قوانينها وأنماطها ومناهجها وأنه غير متخصص، فما ذا يفعل؟ هب أنه تحدث عن ظاهرة ثقافية، وتلقى الرد نفسه من المختصين في الدراسات الثقافية والانثروبولوجيا، أو أنه تحدث عن ظاهرة اجتماعية أو عن حالة نفسية لشخصيات تاريخية أو عن تقلبات مناخية وأحوال جوية أثرت على مجرى أحداث تاريخية. أين تخصصه من كل ذلك؟ إذا نزعنا منه كل ذلك، ماذا يبقى له؟ مجرد أحداث متسلسلة عبر الزمن؟ تنزع منه الفلسفة كل مباحث السببية ومقولات الزمان والمكان والحدوس المتعلقة بها، وعندها ربما لا يبقى الكثير. وماذا لو تركتنا التاريخ كماض، ورجعنا إلى التأريخ، كحقل إنتاج معرفي، هل سننزع منه كل من لن تنطبق فيه معايير الدكتور التخصصية. تصور مثلا أن نرمي بعيدا بابن خلدون، وبكانت وهيغل وفيكو وبيركارت وماركس وديلتاي وكونت وماكس فيبر ودوركايم وهوسيرل وبول ريكور، واللائحة طويلة.
أما في موريتانيا، فلا يخفى على الدكتور أن كل من قدموا أطروحات وإبداعات تفهم بعمق المجتمع التي تؤرخ له كانت لهم عدة علمية كبيرة واطلاع واسع على العلوم الإنسانية والشرعية ولم يكونوا سجناء قيود الحقل الضيقة: خذ مثلا الشنافي، ددود ولد عبد الله، عبد الودود ولد الشيخ، محمدن ولد اميين، محمد المختار ولد السعد، أحمد مولود ولد أيده، وغيرهم كثير. ولا يقتصر الأمر على موريتانيا وليس خاصا بحقل التاريخ، بل "إن كل علم إنما وجد صانعوه المهرة الذي حققوا أفضل نجاحاته في صفوف المهمشين في الأطراف من الهاربين من حقول مجاورة"، كما يرشدنا مارك بلوك في شذرة لطيفة ضمنها أحد هوامش كتابه: دفاعا عن التاريخ أو مهنة المؤرخ.
تاريخية المؤرخ وانعكاس المعرفة
إن أكبر مشكل تعانيه الوثوقية التي تحدث منها الدكتور عبد السلام هو أنها لا تستبطن منهجها التاريخي وتطبقه على نفسها، بمعنى أنها ليست نقدية ولا انعكاسية، إنها تعرف الكثير عن الماضي، ولكنها لا تعرف إلا القليل عن طرق معرفتها لذلك الماضي ولا عن كيانها كذات عارفة ولا عن الديناميات الاجتماعية التي جعلتها تسلك هذا المسار، دعك من الخلفيات الاجتماعية والثقافية التي جعلت أصلا هذا النمط من معرفة الماضي ممكنا ومرغوبا. وهي كلها منعرجات بحثية وآليات وعي بالذات لو أن المؤرخ توخى فهمها والانطلاق منها -بدل الانطلاق من المقولات الجاهزة للسنة الأولى من الجامعة- لكانت منطلقا بحثيا يصقل كل المعارف والمدركات ويضعها في سياقها الذي يجب أن توضع فيه. ولكن وحتى لا نسهب في الموضوع، دعونا قليلا نسائل الوثوقية التي انطلق منها الدكتور عبد السلام من الناحية المعرفية المحضة أولا. عندما يصرح الدكتور أن الحديث في التاريخ يجب أن يُترك بالكلية للمختصين في التاريخ، فإن هذه المقولة تطرح العديد من الأسئلة المهمة، ربما يكون أقربها: إذا كان كل حديث يحتاج لغة فهل يجب أن يكون المؤرخ مختصا في اللغة أم يكفيه اختصاصه في التاريخ؟ هل يجب أن يختص في كل منهج من المناهج التي تُتَوسّل بها دراسة التاريخ: هل مثلا يجب أن يختص في المنهج الفيلولوجي إذا أراد دراسة وثيقة؟ هل عليه أن يعتمد تحليل المضمون أم يترك ذلك للمختصين فيه في العلوم الاجتماعية؟هل يمكنه أن يلجأ لتحليل الخطاب أم أن ذلك خاص بدارسي اللسانيات والآداب؟ وماذا عن المنهج الجدلي هل يعتمده أم يتركه للمتفلسفة؟ هل يمكنه اللجوء إلى التحليلات الإحصائية أم أنها حكر على دارسي العلوم الاقتصادية؟ وهكذا يتبين في النهاية أن المناهج المعتمدة في العلوم الإنسانية متداخلة وأن ظواهرها ومواضيعها متشابكة وأحيانا متماهية، لا تختلف فيها إلا زاوية النظر أو السردية العامة التي ستدمج فيها. ومن هنا فإن كل حديث عن الاحتكار فيها أو الحصرية، من الناحية المعرفية المحضة، ضعيف الاستناد واهي الأركان ولا ينفك يقص الدعائم التي يقف عليها.
إن مثل هذا الوعي بالذات هو ما يجعل الباحث لا ينسى وجوده ويدركه كمنطلق لبحثه، أي أنه يفهم الكتابة بوصفها نشاطا داخل عالم حياتي: هو وجوده وليس العكس. نفس الشيء ينطبق على التاريخ المكتوب، إذ أن فهمه يقتضي مقاربته بوصفه رؤية فكرية منفصلة لعالم حي معيش لا يمكن وصفه ولا نقله كما هو وإلا فإننا سننتج خريطة "بورخسية" تعادل الأرض التي أرادت أن ترسم. وفي الحقيقة فإن ماضي أي مجتمع -وخصوصا عنما يتعلق الأمر بمجتمع كانت الكتابة الوصفية فيه شبه منعدمة وكانت الآثار المادية فيه قليلة- لا يجلس هناك بكل تفاصيله ينتظر المؤرخ حتى ينتهي من مساره المدرسي ليكتبه. زد على ذلك أن المؤرخ ليس لديه الوقت ليطلع على كل تفاصيل وشواهد ذلك التاريخ، وإلا سيحتاج أن يُعمَّر مقدار عمر الفترة التي سيدرس وأن تتعدد أشخاصه وأقانيمه تعدد المجتمع الذي سيدرس. إذا أضفت لكل ذلك، أن المؤرخ (في موريتانيا مثلا) يأتي إلى موضوع دراسته وقد تشكلت رؤيته للكون والوجود وتوجهت إدراكاته اتجاها معينا نتيجة مسار طويل، أقل جوانبه أهمية هو صراعه مع المواد التي لا يُتقن ودرجاته -في الباكلوريا مثلا- التي ستفرض عليه في النهاية التخصص الذي سيدرس وتعاطيه مع اللغات المهيمنة في إنتاج حقله، مما سيضطره -تحت ضغط الأساتذة المشرفين- إلى التخصص في جزئية تحمل في داخلها طابع محدوديته والآفاق المعرفية التي أغلقتها المؤسسة الأكاديمية وفاعلوها أمامه. تنضاف إلى ذلك القيود الإجرائية التي تُفرض على المؤسسات نفسها بدافع تسييري وإداري ثم يستبطن الأفراد الذين طبعتهم تلك المؤسساتت بطابعها هذه القيود لتصبح ذهنية ومعرفية. من هذه القيود ما نشأ مع الجامعات الحديثة من تقسيم العلوم الإنسانية عِضِين وإيكال كل جزئية من حياة الإنسان إلى قسم معين يدرسه ويعنى بإعداد المواد والموضوعات المدروسة (تاريخ، علم اجتماع، علوم سياسية…إلخ)، ولكن هذا التقسيم السياسي لا ينبغي أن يخدع الباحث ليفهمه على أنه انقسام أبيستمولوجي في طبيعة المعرفة أحرى أن يتخيل أنه تشتت أنطولوجي في جوهر المادة المدروسة. يجب أن يفهم الأمر على أساس أنه مجرد تكتيك إداري لتسهيل التسجيل والتسيير وجمع التمويلات من الدولة والمؤسسات المجتمعية الأخرى التي قد تعنى أكثر بموضوع دون غيره من الموضوعات. إن أي شخص يأخذ نفسه على محمل الجد لا يصرف جهده في عمل بحثي محدود بحدود إجرائية ولا يُكَبل ملكاته الإدراكية بقيود تحطم الموضوع المدروس وتخلخل الذات الدارسة بشكل جوهري. صحيح أن الانفتاح على موضوع ما قصد مقاربته معرفيا يحتاج من الدارس نوعا من "الوضع بين مزدوجتين" وحصر الموضوع في لحظة الدراسة، ولكن هذه الوقفة المعرفية في الابتداء لا ينبغي أن يلتزمها الدارس كمسار بحثي دائم. كما أنها ليست سوى نقطة بداية لعل الموضوع أن يتجلى وتتكشف تمفصلاته أمامنا بشكل مفصل، ولكن لا بد بعد ذلك من ربط الموضوع بسياقه وبسلسة الترابطات التي تشكل عالمه وتعطيه معناه. ومن هنا تبرز الحاجة إلى الانطلاق في التأريخ للمجتمع الموريتاني من هواجس موريتانية وليس من منطلق المحاكاة لما أُنتِج استجابة لهواجس وحركات مجتمعات أخر أو نتيجة ضغط مؤسسات بحثية تعمل وفق الطلب السياسي والثقافي لمجتمعات مختلفة كليا. ثم إن معرفة الباحث العميقة بالمجتمع المؤرّخ له شرط ضروري لا محيد عن استكماله، وهو شرط انتبه له بدقة الدكتور أحمد سالم ولد عابدين في تفاعل طريف له مع ما أثير من نقاش حول الندوة المذكورة. لقد توقف الدكتور أحمد سالم عند أهمية "التفقه في طبائع المجتمع" المدروس وجعله مقدمة لما أسماه "القابلية للتأريخ"، ذلك أن متابعة حركية مجتمع ما عبر الزمن ورصد ثوابتها وتغيراتها تحتاج أولا وقبل كل شيء معرفة دقيقة بموضوع الحركة والسكون والانتباه لدقائقه التي يبدو عليها السكون وهي في داخلها في تقلب دائم، وإلا فإن الباحث سينتج تاريخا منبتا عن عالمه الذي يمنحه معناه (deworlded). وليس القصد هنا أن نطالبه، مثلا، أن يكون "حوليا" فيفصّل لنا البنى "طويلة الأمد" ويعزلها عن "الظرفيات" التي تطبع الحياة لفترة معينة ويمايز بينها وبين "الأحداث العابرة" التي تمر وتنقضي بسرعة. إن تاريخا اجتماعيا كهذا قد لا يتناغم مع نظرية الدكتور عبد السلام أحادية التخصص على انغلاق. إنما القصد الأساسي هو التنبيه إلى أن فهم الأحداث والظرفيات قد يستدعي الوقوف عند عقليات معينة ودراستها ورصدها بدقة وبعدة متكاملة تنصت لهواجس المجتمع وتتوسل بمختلف مناهج وأدوات العلوم الاجتماعية. وربما يكون أكبر مهمل في هذا المجال بالنسبة للتأريخ الموريتاني هو قضية التأريخ الألسني ولانتباه لمسار التعبير المجتمعي ولتطوره الداخلي.
هل يمكن أن نتعاطى التاريخ بدون لغة؟
إذا افترضنا أن "اللغة هي منزل الكينونة"، فلا مفر أن نقبل بأن أي محاولة لفهم الإنسان الموريتاني وهو يتحرك عبر الزمن لا يمكن إلا أن تمر بفهم حركية التعبير والتخاطب لديه. ثم إن النظر بعمق في هذه النقطة يطرح إشكالات جُلَّى حول كل ما كتب عن المنطقة التي تعرف اليوم بموريتانيا، خصوصا إذا ما انتبه الباحث، وكان ذا وعي تاريخي وألسني تسعفهما معرفة عميقة بالعلوم الإنسانية، إلى أن ما كتبه المؤرخون القروسطيونيصعب أن تأخذ منه صورة دقيقة عن العقليات نتيجة لاختلاف الصورة الذهنية التي قد ترسمها لديك تعابير من فصحى القرون الوسطى عن تلك التي تشبعت بالصنهاجية والآزير والحسانية. إن اللغة تدخل في صميم العقلية وطرائق التفكير، وبالتالي فإن التعبير بلغة عليا عن مجتمع هامشي مقارنة بمجتمع "المؤرخ" غالبا ما تصاحبه نظرة تعال تجعل التاريخ المدروس مكونا من غرائبيات هامشية وتستحق الهامش، لإنها جرت في الأطراف العاجمة التي لا تفصح بالفصحى. أما ما كتبه الأوروبيون، على وفرة معلوماته وصرامة كثير من تحليلاته، فإن سؤال اللغة يُطرح حوله بإلحاح مُربّع أو مُكعّب أحيانا. ذلك أن ما كتبه الأوروبيون عن المجتمع كان، خصوصا في ما يتعلق بجوانبه الرمزية والثقافية، ترجمة حداثية ودولتيةلمعطيات جزئية انتقاها أعوان الإدارة وتراجمتها من معلومات مُصَفاَّة أَمَدّهم بها شيوخ القبائل وسدنة الحرف والكتابة في المجتمع المدروس.
إن أهمية اللغة في التأريخ للمجتمع الموريتاني تحيلنا إلى واحدة من أعظم الصعوبات التي تواجهنا ونحن نقرأ للدكتور عبد السلام، ذلك أن اللغة التي اختارها الدكتور هنا لكتابة نشرياته فارغة بشكل مُريع من أي تدبر وجودي أو عناية بالحياة في ما وراء الروتين المؤسسي والأنشطة العرضية والإجرائية التي تُؤدّى كأشكال لها شكليات معينة تُعرّفها. إنها لغة يبدو أن كل هَمّها هو التنازل من قصور عن حمل وِزْر الكينونة من خلال الفعل الكتابي والبحثي نفسه. ثم إنها قبل ذلك لغة غير تاريخية ومنفلتة كل الانفلات من أي عقال منطقي، حتى من تلك الضوابط الأكثر بداهة في المنطق العتيق. فالدكتور، ربما لأنه يعتبر أن المنطق غير ضروري لتخصصه، مولعبالتعميمات الكبيرة التي يوردها برهنة على جزئيات محددة، دون أن ينتبه أو يُنبه إلى أن "علاقة العموم والخصوص المطلقين" تقتضي أن إثبات شيء عرضي لكُلّ متسع قد لا ينطبق بنفس الدرجة على كل جزء منه. انظر مثلا عندما صدح الدكتور بأن "المصادر الوسيطة (أي مصادر؟) تشهد (أي أن كُتابها جابوا المنطقة ذهابا وإيابا ولم يكونوا مجرد ناقلين من بعيد، بل كانواشهودا وشاهدوا وضعية مشهودة واقعة على رؤوس الأشهاد) أن سودان (ما هو معيار السودنة هنا) الصحراء (كل الصحراء) كانوا أضعاف (كم ضعفا؟؟) البيضان" (ما هو العامل الحاسم لتصنيف مصادر الدكتور الوسيطة للناس حينها على أساس أنهم بيضان؟).
ثم يعود الدكتور قائلا: كما أنهم الأقدم في البلاد؟ ودون أن نسأل الدكتور عن مصادره في تحقيب أقدمية الاثنيات في البلاد، نقف مندهشين أمام أسلوبه في عطف الجمل: هل (كما) التشبيهية هذه لتشبيه هذه الجملة بسابقتها فتكون المصادر الوسيطة تشهد بها أم أنها مثلها فقط في كون الدكتور يجزم واثقا بصحتها. وهنا تكمن واحدة من مشاكل الكتابة لدى الدكتور. فهو، ربما لأنه يستبطن القول بانغلاق التخصصات بعضها أمام بعض، لن يلتفت إلى اللغة التي يكتب بها، لأنها ليست من تخصصه. وهنا تجده يقدم، بكل بساطة وبإطلاق ليس فيه استثناءات، نظريات لغوية تحتاج نظرا معمقا وكثيرا من التفصيل، كإصراره مرة، في موقف تبريري، على إحداث فروق غير بدهية بين "عن" و"في"، بطريقة قد لا تتماشى مع ما تقرر من معاني حروف الجر وفروقها في كتب النحو أو في كتب الأصول.
ومن غرائب الدكتور، الذي يرى أن الحديث "في" علم ما يجب أن يكون حصرا على المتخصصين، أنه اشترط للحديث "عنه" أضعاف ما اشترطه للحديث "فيه"، وهو عكس ما كان يرمي إليه. ثم إنه اشترط للحديث "في"علم ما معرفة كنهه واشترط للحديث "عنه" معرفة ماهيته، وهنا نتمنى لو أن الدكتور تحدث ولو قليلا عن الفرق، من زاوية تخصصه، بين الكنه والماهية. وهل من مصادر؟؟
ثانيا لو أن الدكتور انطلق من فهم عميق غير نمطي لما سمي العلوم الإنسانية لأدرك أن هذا التفريق لا يمكن أن ينطبق بحال من الأحوال عليها. وأنه وليد تفريق ميتافيزيقي قديم بين ذات العارف وموضوع معرفته وأن أي حديث عن أي معرفة إنسانية هو حديث فيها.
بعيد ذلك بقليل، ينبري الدكتور في هجمة ليس لها مضمون ولا أسلحة وليس لها هدف محدد ليحاكم نيات ما أسماه البعض في حملة قوية يبدو أنها تستقصد "رجل التبن الوهمي" ولا أحد سواه. إن مشكلة ما يقدمه الدكتور هنا هو تصوره أن التاريخ "قبيلة محددة ومغلقة" وفي حرب مع الناس الذين يتربصون بها الدوائر والحقيقة أن هذا النوع من التصورات يأتي نتيجة خلط الباحث نفسه بما يُحب أن يتعرف به. إن التاريخ حديث عن الجميع وللجميع أن يتكلم فيه لينتقي التاريخ بعد ذلك ما يستحق أن يحتفظ به من ذلك، وليس في ذلك أي إرادة للتقليل من شأنه ولا الحرب عليه. فحديث الناس، مثلا، عن صحتهم البدنية والنفسية وفي أمورهم الصحية ليس قضاء على أي تخصص، ثم إن العلوم الحديثة ليست أسرارا مغلقة ولا ميادين تحصر على أي شخص، ذلك أن الحصول اليوم على أي شهادة في أي مجال –وخصوصا في العلوم الإنسانية- سهل للغاية.
أما حين يتحدث الدكتور عن تعريف التاريخ فإنه لا يقدم سوى "ثيولوجيا نفي" تكتفي بتنزيه التاريخ عما ليس إياه التاريخ، دون أن تُقدم أي حكم موجب حول ما يمكن أن يكونه. وهو تكتيك جيد لردع المبتدئين عن الحديث في الموضوع، ولكنه لا يفلح على المدى البعيد. تأمل مثلا قوله إن التاريخ "أعقد بكثير" مما يتناول الناس. كل ذلك جيد وسنصدق به تماما، شريطة أن يُثبت لنا الدكتور مثلا أن التاريخ الذي يتحدث عنه، يمكنه مثلا أن يبعث المجتمعات الغابرة ليسألها وهي ملزمة بإجابته، أو أنه يحتفظ مثلا بوثائق وشواهد لا يعلمها إلا هو، أو أن له منهجا ابتكره ولم يطلع عليه أحد سواه. أما إذا لم يثبت شيئا من ذلك فلا أرى أن بإمكانه إسكات الناس عن الحديث في تاريخهم ولا إقناعهم أن كل ما يقولون ليس له صلة بالتاريخ.
لغة الدكتور ثيولوجية بشكل غريب وبطريقة توحي بأن فهمه للتاريخ وللتدريس في جوهره ثيولوجي وجوهراني إلى أبعد الحدود. إن حديثه عما "علم من التاريخ بالضرورة" إسقاط هاو لمقولة عقدية على موضوع بحثي متطور وتطويري. ذلك أن طلاب العقيدة أو دارسي أحكام الردة في جامعة العيون الإسلامية يمكن أن يدرسوا ما علم من الدين بالضرورة بطريقة تلقينية، لأن موضوعهم له نواة صلبة من الأحكام والنصوص والاجتهادات التي لا تسمح طبيعتها، حسب ما حدده مجالها التداولي، بالبحث في موضوعها خارجها. إن لها أسسا مضمونية وشكلية لا تحيد عنها، عكس العلوم الإنسانية التي هي بحث مستمر ليس له أساس مضموني ثابت ويطبعه، في أغلب الأحيان،تطور شكلي ومنهجي لا يتوقف. إن افتراض أن في العلوم الإنسانية ما هو معلوم ضرورة فكرة غير تاريخية وغريبة، حد التناقض، مع تاريخ ومنهج العلوم الإنسانية، الذين ظلا على الدوام أقرب لنهر هيراكليتس أكثر منهمالأي مقولة بارمنيدية.
ثم ما ذا يقصد الدكتور بالضرورة المحددة للعلم في العلوم الإنسانية؟ أين مصدرها؟ ألا تتنافى أصلا مع فكرة التاريخ ومع المسار البحثي الامبيريقي؟ إن هذه المقولة تصدر من تصور بدائي وساكن للعلوم الإنسانية بوصفها مجموعة من المعارف التي تتراكم وتتسع دائرتها مع بقاء صدقية أحكامها وانطباق نتائجها دائما وأبدا. إنها تنطلق من نظرية معرفية تقليدية لم تقف على تغير أنظمة المعرفة وتبدل البراديغمات والطبيعة الإشكالية للعلومالإنسانية، ولم تطلع على ما كتب فوكو وكوهن وفايرباند، لأن أي أخذ في الاعتبار لهذه التطورات التقليدية يلغي كل كلام عن العلم الضروري في العلوم الإنسانية ولا يترك أمامه ثابتا مضمونيا ولا منهجيا، حتى قوانين المنطق التقليدي (الهوية- عدم التناقض- الثالث المرفوع) لا تجد نفسها قواعد ما قبلية ثابتة وملزمة في العلوم الإنسانية.
فهل إن ما يقدمه الدكتور ليس نظرية (Theory) تقدم نفسها كفرضيات شغالة قابلة للتفنيد والإثبات وإنما هو مذهب (Doctrine) مُتصلّب يغازل النضالية قصد تجنيد الأتباع وتحييد "الأغراب"؟
نفس نضالي يتلمّس طريق المبدئية
إن الاعتراف بالإنسان يقتضي احترام حضوره الخطابي والرمزي في أي فضاء يوجد فيه بشكل جسماني. ومن هنا تتأتى ضرورة أن يعكس الخطاب العمومي تعددية العالم الاجتماعي بشكل يكون فيه التمثيل شاملا والتمثل جامعا دون إقصاء اجتماعي ولا مركزية فكرية. ولكن احترام هذا الحضور، رمزيا وخطابيا، لا يقتضي الإحضار قسرا لمن لا يرغب في حضور جلسات شبه خاصة، أعني بذلك أن ندوة ثقافية لتجمع شبابي تُنظم على هامش حياة جالية نشطة في الحياة المهنية قد لا تكون مُطالبة، سياسيا وأخلاقيا، بتمثيل شامل لكل ألوان الطيف الاجتماعي في مجتمعها الأم. لنفترض، مثلا، أن "ممثل" مكون اجتماعي ما لا يرغب في الحضور لأن التزاماته المهنية أهم عنده من حضور جلسة نقاشية..... صحيح أن الحرص على التمثيل والتعبير التعددي ضروري للغاية، ولكن لنقل إنها فريضة تتأكد حتميتها في الحياة السياسية وفي كل ما يمس تسيير الشأن العام وتوزيع الموارد قبل كل شيء آخر. إذا تقرر كل ذلك، تبين أن مطالبة الدكتور عبد السلام للمشرفين على الندوة أن يجعلوا المتحدثين فيها لا ينتمون، في أغلبهم، إلى شريحة واحدة خطوة جيدة في الاتجاه الخاطئ. فلنستثمر إذن هذه الإشارة السلبية استثمارا موجبا (بكسر الجيم وفتحها) فنمنح نضالية الدكتور هذه بعضا من المبدئية ولا نتركها مجرد عبارة عابرة قيلت لأنها تقال عادة ويجب أن تقال دون تفكير في ما يلزم مبدئيا منها بالنسبة للمتحدث نفسه. لا ينبغي أن تُرمى مثل هذه الملاحظة التقدمية والحكيمة وكأنها هذيانٌ إِمَّعِي نابع من ضمير "هُمْ" الغزوي، لأن هذه المقولة الراشدة لا تكتسب كامل دلالتها إلا عندما تكون مقصودة لذاتها ومعبّرا عنها بصرامة مبدئية. ذلك أن مثل هذه الصرامة المبدئية هي ما كان سُينبه الدكتور إلى أن المطالبة بتمثيل مختلف الشرائح في جلسة شبه خاصة موقف لطيف للغاية ولكنه يُملي على صاحبه، وهو طبعا صادق النية، أن يطالب كذلك بهذا التمثيل في الهيكل الإداري والمالي للمؤسسات العمومية التي قد تحتاج مثل هذا التمثيل. ولنُذَكّر بأن الدكتور ظل حتى وقت قريب رئيس قسم في إحدى الجامعات العمومية التي تتلقى تمويلها من ميزانية الدولة. ونحن على يقين أنه لا يخفى على الدكتور أن هذه العدوة الدنيا من الحياة السياسية والثقافية أولى أن تتوجه إليها هذه المطالبة من غيرها، خصوصا وأن هذه الجامعة تُدرس التاريخ ولربما درسته بطريق يُظهر مركزية عنصر معين "وهذا يعطي الحق لبقية الاثنيات في النظر للتاريخ الموريتاني انطلاقا من مركزيتها"، كما كتب الدكتور في نشريته الأولى ضد الندوة.
نشرية إقصائية ومشروع تنويري
بعد كل ذلك، من الغريب حد الاستحالة أن ينبري الدكتور أبو العباس، وهو أحد حملة مشروع خلق فضاء عمومي للحوار الجاد والاستخدام العمومي للعقل، إلى تسفيه أحلام جمع من أرباب الكلمة والفكر اجتمعوا على حديث جامع يتوخى التحاور في مشترك قريب منهم بحيث لا ينفصلون عنه ولا يستطيعون في الوقت ذاته رؤيته بوضوح. لقد كانت أحاديثهم، على اختلافها، مساهمة في الاشتباك مع تاريخنا حتى نخرج من قيوده واستضافة فكرية له حتى نستخرج منه بالفعل ما هو ضامر في ذهنيتناوكامن في فكرنا بقوة لا تتزحزح. ولو نظر الناظر، وهو ينصت بسخاء تأويلي، إلى المحاضرة الرئيسية وتفاعل الحضور معها وفهم ذلك من منطلق ظاهراتي: أنها تعكس تجربة معيشة لكل متدخل مع هذا الشيء الذي نسميه التاريخ الموريتاني، لرأى فيها ما يدفع إلى نوع من الاحتفاء، عل ذلك أن يساهم في خلق فضاء عمومي للنقاش الجاد بطريقة تنزع عن الأحاديث العامة نكهة دوائر الانتماء البدائي وتعفيها من الصدامية الحزبية السائدة في كل مكان. وبالتالي، فإن انفعالية أبي العباس ضد مشروع كان من دعاته تحتاج إلى تفسير ليس هذا محله. لنكتف فقط بالقول إن ردة فعله على هذا النمط من التحاور العمومي لا تتماشى مع خط أبي العباس المثقف العمومي كما عهدناه.
إن هذا المثقف العمومي نفسه الذي كان حامل مشروع ترشيد للخطاب العمومي كان كذلك مثالا للمثقف صاحب الفكرة الذي يدافع عنها في جميع جوانب الحياة، وليس الحِرفي المتخصص الذي يحيا في جزئية معينة تدفعه القيود الشكلية والإجرائية إلى أن يظل حبيس تفاصيلها بعقل أداتي خِلْو من كل فكرة جامعة ومن كل هَم وجودي وكل أفق قيمي. لقد كان مثقف أفكار ولم يكن تقني تنضيد كلمات مختصة ومحصورة لا هاجس وراءها سوى سجل النشر وإكراهات شروط التوظيف. إن أهم ما أتحف به أبو العباس الساحة الثقافية الموريتانية ليس مشاغله وشواغله التخصصية، وإنما إضاءاته التحليلية غير المختصة ومواقفه السياسية وشيء من العناية بكل جوانب الحياة المعيشية للإنسان الموريتاني، وهي جوانب قدم أبو العباس فيها إسهامات ثقافية وفكرية تستحق أن يبنى عليها مشروع نضالي مؤسَّس من الناحية العلمية والفكرية ومُتجذر في الأصالة الذاتية من الناحية الوجودية والقيمية. إن حاجة هذا المشروع للاكتمال هي ما يدفعنا إلى الانحياز بشكل لا رجعة فيه إلى أبي العباس المثقف العمومي ضد منشور ظهر فيه وكأنه يدفع إلى خصاصة التخصص الحصري وإلى إغلاق الأبواب أمام أي تفكير صادق وعميق لا يتحلى بأساورة التخصص ولا يؤدى داخل أسوار المؤسسات المختصة ووفق أشكال وشكليات القيود الأكاديمية.
المدرسية والتخصص
توقف أبو العباس عند نقاط عدة وكنت أتمنى منه لو أسهب قليلا في اعتراضه على ثلاث منها، لأن ما قاله بشأنها يحتاج مساءلة جادة. أولها قوله إن كون الاستعمار الفرنسي في موريتانيا كان لربط المستعمرات جنوب الصحراء بشمالها نمطية مدرسية. فهل يقصد الدكتور أنها سكولائية أم أنها مقولة تخصصية متجاوزة. ولا يخفى ما في الرد بالتخصصية من رفض لحصرية التخصص وانغلاقه. والحق أن رد أطروحة ما بأنها مدرسية هو رد حداثي مدرسي للغاية. لأنه ربط لمقولة بحقبة، كما يقع في عالم الموضة والمنتوجات الاستهلاكية، ثم تركها دون نقاش للوقائع التي تقف عليها. لنفترض مثلا أن علينا تحديد الهدف من الاستعمار بالنسبة لفاعليه. هنالك طريقان أساسيان لتحديد ذلك: الطريق الأول هو افتراض أن معرفة الغاية تحتاج "فهما" بالمعنى الديلتايي -الفيبري لا يمكن بناؤه إلا انطلاقا من الأهداف التي رسمها الفاعل نفسه، والوثائق الاستعمارية والمراسلات الإدارية الفرنسية واضحة بشأن دوافع السلطات الاستعمارية حينها. المقاربة الثانية هي مقاربة "تفسيرية" ترى أن العوامل الموضوعية –الواعية وغير الواعية- هي التي تكشف العلة الغائية لأي فعل وأن ما يذكره الفاعلون أنفسهم لا يكتسي كبير أهمية في هذا الصدد. وفي هذه الحالة فإن تفسيرات الظاهرة الاستعمارية قد تتعدد وتتنوع تنوع خلفيات الباحثين ومنطلقاتهم الفكرية والنظرية. على أن هذه القضية لم تطرح في الندوة المذكورة إلا عرضا، ولم يكن المقام يتطلب الاستفاضة في ذكر كل أسبابها الممكنة وكل التأويلات التي قدمت لها بعديا، فقُدم لها تفسيران: أحدهما أنها للربط بين مستعمرات فرنسا (أي جعل الأراضي التابعة لفرنسا إقليما متصلا جغرافيا)، والثاني أنها كانت لسد الباب أمام إمكانية الاستيلاء على المنطقة من قبل القوى الاستعمارية المنافسة. وهي تفسيرات ممكنة، ولكنها ليست الوحيدة طبعا.
عن المصطلحات والمصادر
ذكر أبو العباس كذلك أن "تراب البيظان" ليس مصطلحا استعماريا، والحق أن ما أشير له في الندوة هو أن "دولة البيظان" كانت مفهوما أنتجته الدوائر الاستعمارية، ويصعب بناء أي تصور له قبل الفترة الحديثة التي أنتجت مفهوم الدولة القومية وأشبعته بمفاهيم الأمة والإقليم وحق تقرير المصير. أما إشارته إلى أن مكونات المجتمع البيظان لم تكن في المجتمع المرابطي، فربما تكون ردا على ما ذكر من أن التقسيم الوظيفي الثلاثي للمجتمع سبق الفترة الحسانية، وهو رد يحتاج نقاشا جديا لرسالة اللمتوني التي أورد السيوطي في الحاوي للفتاوي.
ذكر الدكتور، في رده المدرسي، أن كتب المناقب مصادر تاريخية وهو شيء صحيح في غير الوجه الذي ذُكر فيه. وبالفعل فهي مصادر للتأريخ لمنتجها ورؤيته للكون والوجود وأنماط التفكير والتبرير والصراع الرمزي السائدة في زمنه هو، ولكن يصعب أخذ ما تحدثت عنه بوصفه تاريخا، لأن الوقائع التي تُقدم فيها غالبا ما تكون ذات بنية أسطورية لا يحدها زمان ولا مكان محدد ولا تخضع لترتيب الأحداث. ثم إن سيرورة وقائعها غير سببية أو أن لها أسبابا يستحيل التحقق منها على الإطلاق. أما الإشكالية الأساسية التي تطرحها فوجودية، خصوصا عندما يكون الباحث الذي يتعاطى معها يعيش في عالمها وينتج فيه وله، وليس لمجال تداولي مغاير. ففي هذه الحالة بالتحديد، يكون أي تعاط مع هذه الكتب نابعا من موقف قَبْلي (بسكون الباء) يتأسس في الواقع الذي يُعطي لهذا الباحث مكانة ووجهة تدور في فلك عوالم اجتماعية ورمزية أنتجت كتب المناقب هذه، بنفس القدر الذي ساهمت كتب المناقب في إنتاج هذه العوالم بشكلها الحالي. إن أي تفاعل واع وذا تمش انعكاسي مع هذه الكتب سيدرك صعوبة وضعها في سياق هي من رسمه لنا فارتسم أمامنا كواقع مكتوب (بمعنى الكتابة التقييدية والكتابة التقديرية) ليمتزج بواقعنا بشكل يصعب إدراكه تماما لمن كان في الحقيقة جزءا من عالمه. إن استشكال الشكوى من كتب المناقب لا يمكن أن يكون جديا وقويما إلا متى ما تقبلنا معها برحابة صدر ما تحمله من تبرير لحال المجتمع بشكل يتوخى تأبيده كَمَآل لازب.
هل علينا أن نخاف من تَسَيُّد المادة غير التخصصية؟
إن حديث الأستاذ أبي العباس عن القضاء على المادة غير التخصصية قد يفهم على أنه، في نهاية المطاف، قضاء على الإنسان غير المختص بشكل رمزي، لأنه يستلزم إسكات كل الناس من غير المختصين، وبما أن اللغة والكلام هما أخص خصائص الإنسان فقد لا يكون أخلاقيا تعليقهما أو حظرهما بشأن أحداث ووقائع عايشها الإنسان أو عاش في ظل تداعياتها وعاشت فيه تأثيراتها لفائدة مختصين يعتاشون بها. إن أي قرار يُفرض بشأن هذا الجزء العميق الثاوي في أنفسنا الأصيلة باستخدام العنف الرمزي أو المادي يستوجب مساءلة أخلاقية تضعه في سياقه وتضع كل النقاط والهمز والأمداد على حروفه التي تتوخى أن تنحرف عن حِرفتها الأصلية، ألا وهي الإنتاج المعرفي، إلى أداة حربية تكره الناس على السكوت. لننطلق هنا من مسلمة أن كل إنسان حي له تجربة خاصة مع عالمه الذي يحيا فيه، وليست هنالك تجربة أعلى، من الناحية الأخلاقية، ولا أسمى، من الناحية المعرفية، من التجارب الأخر، إلا إذا تدخلت أو أُدخِلت اعتبارات مفارقة تصنع التراتبية من علٍ. ثم إن من حق أي كان، خصوصا إذا اعترفنا أن اللغة منزل الكينونة، أن يثبت كينونته بالتعبير عن هذه التجربة بطريقته الخاصة. يبقى بعد ذلك، أن الحقول المعرفية تنتقي ما يصلها من الإنتاج الخطابي حسب قواعدها وأدواتها ثم تصطفي منه ما يمكن أن يندمج بداخلها وما يبقى في الفضاء العمومي. نعم، يمكن للمشرفين على كتاب أكاديمي تخصصي أن يرفضوا التعبيرات العمومية عن ظاهرة يدرسونها،كما ينبغي للجامعة أن تُهذّب ما يدخلها من الخطابات، ولكن "تطهير"الفضاء العمومي من الخطاب غير التخصصي فكرة شعبوية، رغم ما في ذلك من مفارقة، ناهيك عما يلوح في داخلها من شبح إقصائي دافعه احتكار رأس المال الرمزي. إن الخطاب العمومي غير منافس للخطاب المتخصص إلا في الحالات التي يضعف فيها الإنتاج المتخصص ويعتصره التقليد وتموت فيه روح المغامرة البحثية فيتحول من رسالة بشارة مفنوحة على الحياة إلى نصوص جامدة تُكرّر وتُعاد لتقتل كل ما في الموضوعات المدروسة من حياة. وفي الحقيقة، فإنه عندما تتكاثر القيود غير العلمية (الربحية، التمويلية...) المفروضة على الخطاب المتخصص، خصوصا ما كان منه مضطرا إلى معالجة هموم مجالات تداولية تحمل رؤية للكون والحياة تختلف عن المجتمع موضوع الدراسة، يقل إبداع هذا الخطاب وصدقيته ومصداقيته فتصبح شرعية إنتاجاته ونتائجه موضع تسآل عام ويعم الإحساس بالحاجة الملحة إلى خطاب مواز لا يستطيع إثبات نفسه، لعدم حرفيته، إلا بالتخلي عن كل قيود الخطاب المتخصص حتى تلك التي تنبع من قيم معرفية وأخلاقية لا بد منها لتماسك أي منتج معرفي. هل يعني ذلك، أن المادة المتخصصة سيقضى عليها؟ كلا، لأنها كلما استطاعت استيعاب الخطاب العمومي وتجاوزه (بالمعنى الهيغلي Aufheben) تزداد صلابتها وقدرتها على الفهم وتكتسب شرعية على شرعيتها الأكاديمية.
اشتكى الأستاذ أبو العباس من غياب الإضافات الكبيرة خلال الندوة، وهو شيء مفهوم في ندوة تتوخى تقديم قراءات وخلاصات عامة للتعريف بموضوع معين وليس من همها بعث إشكالات جديدة تُقدمها هدايا للباحثين المختصين. ولكن هذه الشكوى المحقة يحق لنا أن نتبناها وندافع عنها وندفع بها، لعلها تكون دافعا لإنتاج تاريخي أصيل يتجاوز، بمعرفة واستيعاب، الإضاءات التي قدمتها العلوم الإنسانية وينغرس، بنقدية، في الأرضية الرمزية التي ينوي فهمها.
وإذا كان أبو العباس قد ذكر أن نشريته كانت "شورا" فهم على عكس ما أراد له، فإننا لا نوافقه في تصنيف فاغو (كل فاغو) على أنه لحظة غضب، نعم هو "ظهر" حماس (خصوصا كحاله)، ولكنه ليس "ظهرا" للغضب، ففيه الأناشيد الحماسية وفيه أشوار رقص لا يمكن لأي كان أن يرقص على إيقاعها ( أكنو الحساسنة مثلا). أخيرا، وإذا كان لابد لنا من إسقاط موسيقي على هذا المكتوب، فإننا لا نريد له أن يكون عزفا يقصد منه تهدئة المستمع والقارئ (كموسى السبع مثلا) ولا إلهاؤه (كمشوش أعمر آبيلي)، بل نبتغي له أن يكون "ردات زمنية" من "سنييمه البيضاء"، تجعل الشخص يقف أمام ذاته العميقة بأصالة ويسائل كل العوارض والأعراض والتمظهراتوالمظاهر حتى لا يبقى في الجبة سواه، وحتى لا يلهيه جزء عن كل أو أداة عن هدف، وحتى لا يتناسى كينونة ما يبحث عنه، انشغالا بالكيانات والكائنات التي لا تتحقق إلا عندما يضيء بها نور الكينونة فتظهر هي ويختفي النور.
د. أحمد ولد محمد سالم